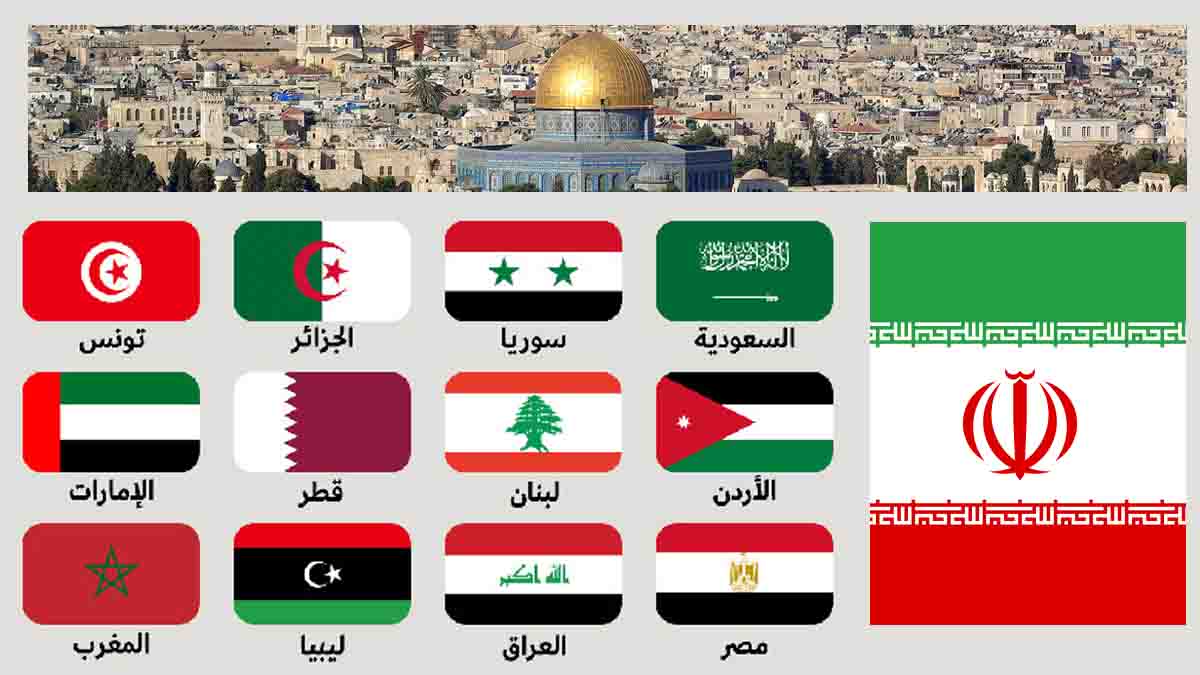خارج النص
كتب رياض الفرطوسي
الذين يتحدثون عن الحقيقة وكأنها طائر حطّ على كتفهم، لا يدركون أنهم ربما يتحدثون عن شبحٍ لا يُرى إلا لمن فقد بصره بالبصيرة. ليس في العالم أكثر إغراءً من وهم المعرفة، وليس في العقل أكثر خيانةً من تلك اللحظة التي يظن فيها أنه بلغ منتهاه.
في الأزقة الفكرية الضيقة التي تشكّل الذهن الجمعي، تُنصّب اللغة ملكة، وتُوكل لها مهمة مستحيلة: أن تُمسك بالماء بأصابع الكلمات. يراهن المثقف على المفردة كما يراهن الساحر على تعويذته، ويظن الكاتب أن صياغةً متقنة قد تكشف سرّ الإنسان، أو تضع الكون في جيب قميص. لكن هل تكفي اللغة لتقول الحقيقة؟ أم أنها، كما قال بول ريكور (فيلسوف التأويل الفرنسي، 1913-2005)، لا تملك سوى أن تلمّح، أن تشير، أن تدور حول المعنى دون أن تطاله؟
كل من أمسك قلماً، وكتب بيقين جازم: “هكذا هو الإنسان”، ارتكب خطيئة فلسفية لا تُغتفر. الإنسان ليس وصفاً، ولا تعريفاً، ولا معادلة. إنه نهرٌ غامض يجري في ظلمة كثيفة، تغيره الحجارة، وتعيد تشكيله المنعطفات. ما تراه اليوم من شخص، ليس إلا ظلًا لما كان، أو ممرًا لما سيكون. أما أن تقول: “أنا أعرفك”، فتلك نكتة ثقيلة لا تُضحك أحداً.
ربما كان زينون الإيلي (الفيلسوف الإغريقي، القرن الخامس قبل الميلاد) محقاً حين صنع مفارقاته ليؤكد أن الحركة وهم. فربما كذلك الحقيقة وهمٌ آخر، لكنها ضرورية لنمضي. نحن نحتاج إلى الظن كي نحيا، لكن كارثتنا تبدأ حين نرفعه إلى منزلة المطلق، حين نحول الرأي إلى يقين، والحدس إلى قانون، والانطباع إلى شريعة.
وحدها العلوم الدقيقة يمكن أن تتحدث بلهجة حاسمة، لا لأن الحقيقة فيها واضحة، بل لأنها قابلة للقياس، قابلة للاختبار، قابلة للتكرار. أما في السياسة، والفن، والأخلاق، والعلاقات الإنسانية، فالحقيقة شجرة ذات ألف فرع، لا يجمعها جذر واحد. رأيٌ في باريس قد يكون تجديفاً في مكة، وابتسامة في كوبنهاغن قد تُعدّ إهانةً في كابول. فبأي ميزان نزن هذه الحقائق؟ ومن الذي يملك مفاتيحها النهائية؟
كل سلطة، دينية كانت أم دنيوية، تهوى صناعة الأرشيف: تصنيف الناس، تغليفهم، ختمهم بختمٍ أحمر، ورميهم في رفّ مهجور. أرشفة الإنسان هي أولى خطوات نزع إنسانيته. كأنك تُجمّده في لقطة، وتقول: هذا هو، ولن يكون غيره. وهذا ما فعله الأنبياء الكذبة، وما فعله ضباط المخابرات، وما يفعله المحللون الذين يملأون الشاشات بإجابات أكثر من الأسئلة.
المفارقة الساخرة أن أكثر الناس حديثاً عن الحقيقة، هم أقلهم تسامحاً مع تنوعها. يرفعون راية الصدق، ويقيمون المحاكم لمن يختلف معهم. هؤلاء لا يبحثون عن الحقيقة، بل عن تأكيد أفكارهم، عن مرايا نرجسية تعكس وجوههم في هيئة منطق.
الفيلسوف النمساوي فيتغنشتاين (1889-1951) قال مرة: “حدود لغتي هي حدود عالمي”. ولكن ماذا لو كانت لغتنا نفسها محدودة، معطوبة، مجازية؟ ماذا لو كانت اللغة قفصاً بديعاً لحقيقة هاربة؟ نحن لا نعيش في عالم المعاني الثابتة، بل في تردد الصوت، في ارتعاش الصورة، في الهامش، لا المتن.
ولذلك، حين يقول لك أحدهم إنه يعرف نواياك، أو يحكم عليك من جملة قلتها، أو موقف بدر منك، تذكّر أن هذا اختزال ظالم، وأنك لست لقطة من كاميرا مراقبة، بل كائن يتغير بتبدّل الضوء، والحرارة، والذاكرة، والخوف، والحنين، والنوم.
ما الحقيقة إذاً؟ لعلها ليست شيئاً يُمتلك، بل فضاء يُسكن. ليست معادلة تُحل، بل علاقة تُكتشف. كما قال جاك دريدا (فيلسوف التفكيك الفرنسي، 1930-2004): “الحقيقة ليست جوهراً، بل حدث”. حدثٌ متكرر، ملتبس، هشّ، مثل لحظة البكاء دون سبب، أو القشعريرة حين تسمع صوتاً يذكّرك بمن تحب.
فلنكفّ عن اليقين، لا لأنه لا وجود له، بل لأن ادعاء امتلاكه هو أول طرق العمى. ولنعد إلى التواضع الجوهري في المعرفة، حيث الحقيقة ليست نهاية، بل بداية، حيث الكلمة ليست نهاية الطريق، بل أولى خطواته المرتبكة.
في عالمٍ يُصاغ على المقاسات، وتُفصّل فيه النفوس على مزاج المجتمع، تذكّر أن أجمل ما في الحقيقة أنها لا تنام في السرير نفسه كل ليلة، ولا تدخل من الباب نفسه، ولا تُعرّف بالمصطلحات. إنها مثل الحب، مثل الموت، مثل الشعر: تُرى أكثر مما تُقال.